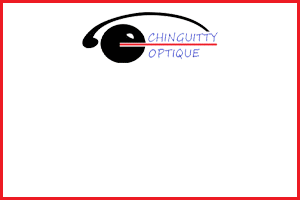منذ سنوات لم أعد أكتب، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً لأنني لست كاتباً بالمعنى الحقيقي، وثانياً لأنني كنت أعاني من نقص واضح في الإلهام. لكنني اليوم أجد نفسي مضطراً إلى العودة إلى الكتابة.
لقد أصبحت أشعر بالقلق مما يُتداول بشكل متزايد في الكواليس، بل ويُقال أحياناً علناً في بعض اللقاءات العامة، من طرف شخصيات قريبة من دوائر السلطة، وبعضها من موظفي الدولة. ولا أهدف هنا إلى الدخول في جدل مع أي طرف، ولا إلى الدفاع عن رأي شخص أو مهاجمة رأي آخر.
أود فقط أن أقدّم نصيحة مبنية على حجج، لمن يريد أن يستمع، بشأن الحديث عن احتمال العبث بدستورنا، لأن هذا هو جوهر الموضوع.
للأسف، أصبح ذلك شبه عادة مرضية: فكلما اقتربت نهاية المأمورية الرئاسية الثانية والأخيرة، ترتفع أصوات تطالب بمأمورية ثالثة. ولماذا لا رابعة أو خامسة؟ أو رئاسة مدى الحياة، بل وحتى ملكية؟
الاستجابة لمثل هذه المطالب، سواء صدرت بحسن نية أو بسوء نية — والله أعلم — تعني خرق الدستور، وخاصة المادتين 26 و28 اللتين تُعتبرانمحصنتين غير قابلتين للتعديل، مقفلتين وفق التعبير المعروف لأحد أبرز واضعي الدستور، الرئيس الراحل اعل ولد محمد فال رحمه الله.
والأخطر من ذلك أن أصحاب هذه الدعوات يطلبون من المعني الأول، والوحيد المخوّل قانوناً باتخاذ مثل هذا القرار، أي رئيس الجمهورية، أن يحنث بقسمه من خلال تعديل الدستور لصالحه. ألم يُقسم الرئيس على المصحف الشريف، أمام الله وأمام الشعب، ممثلاً في مؤسستين أساسيتين هما المجلس الدستوري والبرلمان، على احترام الدستور وعدم المساس بهذه المواد المحمية، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر؟
لقد كان هذا القسم، الذي نُقل مباشرة عبر الإذاعة والتلفزيون وأمام مئات الشهود من داخل البلاد وخارجها، عملاً رسمياً لا يمكن تجاهله بسهولة. ولمن يقول إن الدستور ليس قرآناً، أقول نعم، هذا صحيح، لكنه يبقى القانون الأعلى في الدولة، وهو الذي يضمن تسيير البلاد بطريقة منظمة وعادلة. وخارج هذا الإطار لا يبقى إلا الارتجال، وهو غالباً ما يقود إلى الاستبداد.
لقد عرفت دول كثيرة عدم الاستقرار السياسي، وبلدنا للأسف من بينها، إن لم يكن في مقدمتها، بالنظر إلى عدد الانقلابات التي شهدها منذ سنة 1978. أما دستورنا الحالي، الذي أُعدّ واعتمد عبر استفتاء شعبي سنة 2006، فقد كان ثمرة حوار صريح وشامل بين رجال ونساء مخلصين، بعد سنوات من النضال والتضحيات التي قدمتها القوى الحية في البلد والوطنيون وأحزاب المعارضة.
وقد جاء هذا الدستور ليعالج أهم مشكلة تواجه الديمقراطيات الهشة، وهي التداول السلمي على السلطة. فالنص صريح على تحديد المأموريات الرئاسية بمأموريتين فقط، وتعزيزه بالقسم الإلزامي على القرآن عند تولي المنصب، سمح بحسم هذه المسألة نهائياً، إلا بالنسبة لمن لديهم تعلق غيرسليم بالأنظمة السلطوية وصورة الحاكم المستبد.
أما أنا، فقد كنت دائماً من أنصار تحديد المأموريات، لسبب بسيط: فالرئيس إنسان، يتأثر بمرور الزمن، ويصبح أكثر عرضة لتأثير محيطه، وقد ينزلق — دون قصد — نحو ممارسات سلطوية. والأمثلة على ذلك كثيرة في العالم، وخاصة في إفريقيا، رغم وجود الميثاق الإفريقي للحكامة الذي التزمنا به طوعاً.
وقد تعزز هذا الاقتناع لدي بسبب حدثين عشتهما شخصياً.
الأول كان سنة 2015، عندما كنت عضواً في البعثة البرلمانية الموريتانية لدى دول ACP والجمعية البرلمانية المشتركة ACP/الاتحاد الأوروبي. في تلك السنة اندلعت أزمة سياسية خطيرة في بوروندي، حين سعى الرئيس بيير نكورونزيزا، بعد انتهاء مأموريته الثانية، إلى الترشح لمأمورية ثالثة بحجة أن مأموريته الأولى كانت نتيجة انتخاب غير مباشر من طرف البرلمان.
لم يقبل الاتحاد الأوروبي هذا التبرير، ففعّل المادة 96 من اتفاقية كوتونو وعلّق تعاونه مع بوروندي. وبالنسبة لبلد هش أصلاً، كانت النتائج كارثية: قمع، مئات القتلى، آلاف اللاجئين، وانعدام للأمن ومجاعة. وبعد خمس سنوات من المعاناة، عيّن نكورونزيزا خلفاً له هو إيفاريست ندايشيمييه الذي فاز في انتخابات مايو 2020، ثم توفي نكورونزيزا بعد شهر واحد. ومنذ ذلك الحين استؤنف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبدأت البلاد تتعافى تدريجياً.
يقول البعض إن أوروبا وأمريكا ليستا من كبار المانحين لبلدنا، وأن مساعداتهما يمكن الاستغناء عنها. ربما، لكن قدرتهما على التأثير السياسي والدبلوماسي تبقى حقيقية، وأحياناً حاسمة، ولذلك فإن الحذر واجب.
أما الحدث الثاني فكان سنة 2017 في بروكسل ثم في بورت أو برانس، خلال الاجتماعات التحضيرية وقمة الجمعية البرلمانية المشتركة ACP/الاتحاد الأوروبي. فقد وجدت موريتانيا نفسها مستهدفة بعدة مشاريع قرارات شديدة اللهجة، تتهمها بمختلف التهم: العبودية، العنصرية، انتهاكات حقوق الإنسان، ضعف الديمقراطية، وسجن المعارضين.
وبعد مفاوضات صعبة، كان أحد أهم الحجج التي قدمناها أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ستجري دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته بعد إكمال مأموريته الثانية والأخيرة. وقد سمح هذا الالتزام الدستوري بالتوصل إلى قرار توافقي صُوّت عليه بالإجماع، مما جنّب بلادنا إحراجاً دولياً أمام 104 دول. وبعد ذلك زارت بعثة برلمانية مشتركة نواكشوط وأصدرت بياناً إيجابياً أنهى هذا الملف نهائياً.
وهكذا، فإن مجرد نص دستوري واحد — وهو تحديد المأموريات — مكّن بلدنا من تجنب العقوبات والعزلة والإساءة إلى سمعته الدولية.
ويمكنني ذكر أمثلة أخرى كثيرة لتعديلات دستورية انتهت بانقلابات أو حروب أهلية ومعاناة كبيرة للشعوب، وغالباً ما يحاسب التاريخ من يقفون وراءها.
وفي الختام، فإن الذين يطلبون من رئيس الجمهورية، عن قصد أو دون قصد، أن يتراجع عن قسمه، لا يدركون خطورة مثل هذا المسار، لا على البلد ولا على الرئيس نفسه. كما أن ذلك سيجعل أي حوار سياسي مرتقب محل شك كبير، إن لم يجعله مستحيلاً.
ومن المفيد أن يوجّه الرئيس رسالة واضحة إلى هؤلاء المطبلين، يدعوهم فيها إلى التوقف عن هذه النقاشات العقيمة، والتفرغ لقضايا أكثر إلحاحاً مثل تحسين الحكامة، ومحاربة الفساد، وخلق فرص عمل للشباب.
فلنتجنب فتح صندوق باندورا من جديد. بلدنا هش، والسلم الأهلي الذي نعيشه اليوم — الحمد لله — يجب الحفاظ عليه بكل الوسائل. ومنطقة الساحل تعيش حالة اضطراب، وعدم الاستقرار ينتقل بسرعة.
والباقي مغامرة غير محسوبة.
والله من وراء القصد.

.jpeg)
.jpeg)






.gif)