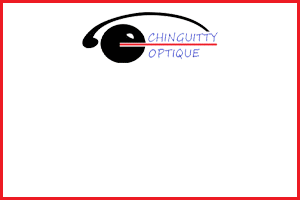في رثاء رجل صادق
قلة هم الذين حملوا أسماء تليق بهم، فتمثلوا حال أسمائهم بأفعالهم، فلما هتف له الوحي سميه محمدا فلأنه كان محمدا حقا، عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن محمد كان محمود وأحمد، وتلك أسماء لا يليق أن يحملها إلا الكبار خلقا وخلقا ومكانة وصنائع، مثل الشهيد عمر المختار الذين حمل اسمين عظيمين، فما أدراك من عمر وما أدراك من المختار، ومثله شأوا الراحل أحمد قايد صالح، الذي حمل بدوره اسمين عظيمين، فما أدراك ما أحمد وما أعظم الصلاح، والميزة أن كلا الرجلين حمل السلاح وقاتل من أجل قضية نبيلة فعاش حرا ومات كريما.
الهمم الكبيرة
لمناسبة الحديث عن السلاح والقتال، لماذا يقولون أطلق النار على العدو، مع أن الذي ينطلق ويصيب هي رصاصة معدنية بغلاف نحاسي، ثم إن النيران تطلق عادة على الأعداء، فلماذا نرى نيرانا كثيرة تطلق على الجيران والأصدقاء والأهل والأنفس؟.
كان الزعيم الراحل ياسر عرفات يتغنى كثيرا بمصطلح "شعب الجبارين" وأنه من حسن طالعه قاد الجبابرة في طريق النصر المبين الذي لم تتضح ملامحه بعد، وكل الذي رأيناه وعايناه مزيدا من الهزائم والانكسارات والتقوقع، لتصدق مقولة عرفات ولكن بالاتجاه المعاكس، على عكس برنامج فيصل قاسم الذي برع في استدراج ضيوفه لمصارعة الديكة المنتوفة، فاكتشفنا شعوبا من الجبارين، نال منهم القهر والقسمة والضرب، وليس شعبا واحدا وهم جبابرة في الاحتمال والصبر والتسويف.
وفي أمة تطلع عليها شمس الله وتغرب، تحققت فيها العمليات الحسابية من ضرب وطرح وقسمة وجمع، ورغم البؤس الحسابي، خيب الجنرال الجزائري الراحل ظن الروائي الرائع غارسيا ماركيز، خصيم الجنرالات ومنتقدهم، بتميزه عن القادة العسكر في الحكمة والصبر والإخلاص، وتلك ثلاثية يندر أن تجدها في عسكري إلا إن كان من صحابة رسول الله مثل أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وفقيد الجزائر من النادرين الذين قادوا سفينتهم في بحر مضطرب، فسلمت سفينتهم بسلامة قومهم، لسلامة نواياهم، ولم يلجأ للرصاص متعدد الأنواع والأشكال، وخاصة المطاطي الذي تخلى عنه الصهاينة، وصاروا يقتلون شباب القدس برصاص حي، والمفارقة المؤلمة، هل يكون الرصاص حيا؟.
يا لعجائب اللغة، للمناسبة احتفى "نتانياهم" بأنه الأطول عمرا في حكم دولة الكيان الصهيوني، حيث تقدم على بن غوريون المؤسس، ولعل أخطر أنواع النيران الرصاصية هي التي تطلقها الألسن وأجهزة الإعلام، التي خلقت جوا ضبابيا قاتما ومشبوها ومشوها من الضلال والفساد وأشاعت شائعات البؤس، التي أخذ الناس يلعنون فيها أوطانا لم تحقق لهم كرامة ولا وجودا ولا حتى مجرد صوت.
سيزيف العربي
حامل الصخرة الأسطوري، الذي كلما هم أن يصل إلى قمة الجبل تدحرج مع صخرته يعيش في الوطن الكبير الذي غنى له عمالقة الفن العربي، "وطني حبيبي الوطن الأكبر" وهو يكاد يتلاشى ويتبخر بفعل أحلام القادة الصغيرة، التي لم تعد تميز جنسية الوجوه والهويات التي تنطلق النيران تجاهها، وقد سأل أحدهم قبل عقود، هل تطول الأعمار ونعيش ذلك الوقت الذي يصبح فيه الأخ عدوا ويضحي العدو صديقا؟.
في الجزائر وصلت الأوضاع قبل اليوم حد الخطر الذي يقتضي التكتم؟ والواضح أن البلاد كانت تعيش حربا أمنية مخابراتية حساسة ودقيقة ومصيرية، تقمصت ثوب الفساد الإقتصادي والمالي، وهي في حقيقتها معركة من أجل السيطرة على الشارع ودفعه نحو الانفجار وتساءل ابن الشارع من تكون عصابة الظل هذه؟.
القلة التي خرجت تهتف ضد الاستبداد والفساد، تلقفت مصطلح الفريق الراحل عن "العصابة" وصارت تردده بغضب وتصميم، وليس جميع من هتف وردد من المخلصين، فقد كان بعضهم مضللا وأكثريتهم يعلمون طبيعة الوتر القاتل الذي عليه يعزفون، ولست أدري بالضبط لم هو "ابن شارع" وليس ابن الجامعة أو المصنع والمؤسسة، وابن الشارع عند العوام، هو فوضوي وقليل تربية ووعي، وهذا لا تنطبق عليه مواصفات ابن الحراك والمظاهرات إلا إن كان من الغوغاء الذين كلما سمعوا زغردة رقصوا دون أن يعرفوا هوية المحتفى به.
زجهم زجا
الصراع الخفي فتح باب الفساد الأمني الذي جرت معالجته بصمت، وبتعبير أدق هو ما خلقه الحضور المخابراتي في الشأن الاقتصادي من فساد مالي وسياسي وإداري وثقافي، وعلاج هذه الكارثة ليس بالأمر السهل، وليس بمقدور هيئة واحدة تحمل تبعات مكافحته، وإنما يحتاج الأمر لجهود الجميع وفي زمن قد يطول، وقد يكون الرئيس عبد المجيد تبون أكثر المسؤولين دراية بحجم خطورة هذا الفساد وكيفية القضاء عليه، ورغم ذلك من كان يرجو أن يزج بكل أولئك النماريد في مكان واحد اسمه "سجن الحراش"؟.
بانتظار الوصول إلى مرحلة تؤسس لعمل سياسي مخلص ونظيف في بلد متخلف، يحتاج لنبي كي يصلح أحواله، وإلا هل بعث الله تعالى الرسل إلا للمتخلفين ذوي القلوب الضيقة المتحجرة، فالواعي المتحضر الفطن، لا حاجة عنده لنبي يبصّره ويرشده، فهو يعرف الحق والصواب والخير، لكن عندما ينحرف المجتمع بانحراف الفرد من الرأس حتى القاعدة، وهي ليست "قاعدة ابن لادن" على أية حال، فهذا طار عن قاعدته إلى محيط اختاره الأمريكان قبرا له، فساعتها أي عند الانحراف نحتاج لنبي مرسل، لكي يصحح مسارات قوم قد ضلوا وأضلوا، فهل نحن من الضالين؟.
الإجابة ترسمها الخارطة السياسية والاجتماعية، هذا إن كانت عندنا خارطة أصلا، وفينا من يسميها خريطة سياسية، ولمن يجهل فـ"الخريطة" من خرط يخرط خرطا فهو خارط ومخروط، والخرط هو الفرم والتجزئة، والمخروط إما أن يكون مفروما أو يكون شكلا هندسيا مخروطيا، ونحن مخروطون في مخروط.
أما من خرطنا ولماذا ومتى؟ فتلك أسئلة يملك الإجابة عنها، من يعتقد أن المناصب ليست كالمقولة التي أكرهها " المسؤولية تكليفا وليست تشريفا" فهذه شعارات الحمقى والمحرومين، ولأننا نحترم عقولنا، نعتقد أن المسؤولية لا تعني الجلوس فوق رؤوس الناس واستمراء الجلوس وبالتالي عدم الوقوف بعدها، وإنما هو المساءل عن مسؤوليته، بمعنى أنت مسؤول أمام غيرك وهو الذي يسألك عن فعل المسؤولية.
هنا المحظوظ فينا من أخطأته المسؤولية وذهبت إلى غيره، والحق لست أدري أية متعة يستشعرها المرء في الجلوس فوق الرأس، مع أنها جلسة غير مريحة أبدا، ولا بد لصاحبها من التململ دوما، خاصة إن كان يعاني من البواسير والنواسير، وقد يكون ثمة علاقة سرية بين الرأس والقاعدة.
فهل من يعي ويستوعب ويعقل فيعمل؟.
الكاتب الصحفي والشاعر/احمد يحياوي
ردإعادة توجيه

.jpeg)
.jpeg)






.gif)