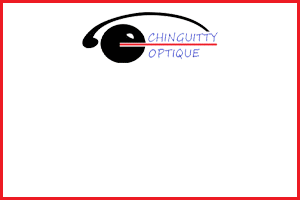إن موتنا هو بالفعل غير قابل للتصور، و كلما حاولنا تخيله نجد أننا في الواقع نستمر في الحياة كمشاهدين.
و لذلك فالمدرسة النفسية التحليلية قد تجازف بالقول أن لا أحد في أعماقه يؤمن بفنائه، أو بعبارة أخرى، في أللاشعور كل منا مقتنع بخلوده.
سيجموند فرويد.
حقيقة الموت أو الفناء طال ما شغلت الفلاسفة، وفي النظرة الفلسفية التحليلية العميقة للفيلسوف و الطبيب الكبير "سيجموند فرويد"، نجد أنه يفند إدراك الشعور بالهدم (الموت) بأللاشعور الذي يرفض الفكرة مبدأ، و ذلك أن التفكير البشري يرفض الهدم أساسا بشكل فطري، إذ أنه من غير المعقول التعارض مع النسق المادي التلقائي للحياة الذي يترجمه الأنسان في كل مراحل حياته و على جميع الأصعدة مع فلسفة الإنسان الذي هو جزء من هذه الحياة، و إلا كان ذلك تناقض، و هو ما لا يستقيم عقلا إذ أنه في فلسفة المنطق: لا يمكن أن يجتمع المتناقضان، فكان لزاما أن تسطو إحدى الفكرتين على الأخرى.
وهذا أمر جلل، و أظن أن الفلسفة العقائدية و علم اللاهوت كانا من العناوين الرئيسية التي ساهمت في تحليل النظرية قبل" سيجموند فرويد" و الفلاسفة المسلمون كانت لهم صولات و جولات في هذا الموضوع بالرقم من أن المسألة بالنسبة للمسلمين محسومة مسبقا، فالموت ليس إلا إنتقالا من حياة دنيوية إلى أخرى أخروية حيث الخلود فإما نعيم أو جحيم.
ولكن "سيجموند فرويد" أراد أن يناقش الأمر بعيدا في غيابات الفلسفة و علم النفس و هو أمر ربما يكون أكثر إقناعا لشخص مثله لم تتولد فكرت الخلود الأبدي في داخله عن قناعات أو معتقدات دينية، على خلاف غيره. و من الفلاسفة من رأى غير ذلك، فمثلا سقراط مع أنه لم يؤمن يوما بفكرت الخلود إلا أن ما قاله في محاورة الدفاع قد وشا بما في نفسه من أمر الخلود حيث قال( ذاك أني أؤمن أن هناك آلهة و إيماني بالآلهة أسمى في معاناه من إيمان أي من أولئك الذين يتهمونني، و حيث أن هناك آلهة فما من شر يمكن أن يحيق بالرجل الخير سواء في الحياة أو بعد الموت)، و هو ما حدث بالذات مع أفلاطون في نفس المحكمة إذ أن رباطة جأش سقراط و صرامته في مواجهة الموت كانت السبب في أن يستحضر أفلاطون الرواية الفيشاغورسية التي تقول (إن الجسم هو سجن النفس و أن الموت ليس النهاية...) و هذا بالفعل ما أكده "فالتر كوفمان".
لم يحظى الموضوع بكثير من النقاش عند الفلاسفة المسلمون و ذلك لأسباب سياسية بحتة وإن كانت الذريعة هي الدين و حماية المعتقدات وهذا للأسف ما أدى في ما بعد إلى الإنحطاط الفكري و الثقافي بعد أن ذاقت الأمة طعم الإزدهار المعرفي، فبين ما كان الفيلسوف و العقل العظيم "إبن رشد" يحاول أن يوافق بين الفلسفة و الدين بشكل منسجم و محكم و خاصة في كتابه (فصل المقال)، كان المشرقيون يقومون بحملة على الفلاسفة و المتكلمين فمثلا الإمام "أبو حامد الغزالي" و بالرغم من دوره العظيم في تجديد الدين و الذي تمثل في كتابه (إحياء علوم الدين)، إلا أنه كان له دور تعسفي إزاء الفلاسفة و كما هو معلوم فقد رد عليه "إبن رشد" بكتابه (تهافت التهافت)، ولكن للأسف أن هذا الأخير أيضا كانت نهاية مشروعه النهضوي على يد "المنصور" و لنفس الأسباب(سياسية)، و تحت نفس الذرائع (دينية)، ف"المنصور" الذي أمر بحرق الكتب الرشدية أمام العامة و كان يعكف على قرائتها في خلوته.
طبعا إبن رشد كان يقول بخلود الروح، و لكن عدم بلورته للأمر أثناء شرحه لنظريات "أرسطو" أسدل نوعا من الغموض على موقفه، و هو ما دعى إلى إتهامه من قبل اللاهوتيين و غيرهم، و لكن كل من تتبع "إبن رشد" سيجد أنه كان مؤمنا بالخلود شرعا و عقلا، و إنما إختلافه مع الأشاعرة و غيرهم كان في أمور أخرى.
إن مسألة الخلود تحمل في طياتها الكثير من المعاني و التأملات الفلسفية التي تحيل إلى آفاق أعمق، فحقيقتها من عدمها ليست هي المشكلة، إنما المشكلة تكمن في واقعية إثباتها و ترسيخ الإيمان بها، فمن لم يستسقي حقيقتها أصبح الموت هاجسا ينذر بفنائه و عدمه...
ولكن الأعوص هم من يؤمنون بحقيقة الخلود أو _يدعون_ ذلك و لا يجدون في أنفسهم حرجا من التغافل عن تلك الحقيقة، و أخص بالذكر هنا (المسلمون)، و هذا يعيدنا إلى قول "سيجموند فرويد" _إن موتنا هو بالفعل غير قابل للتصور، و كلما حاولنا تخيله نجد أننا في الواقع نستمر في الحياة كمشاهدين_ فهل عجز الإسلام عن إقناع العقل بالحقيقة(الخلود)، أم أن العقل قصر في إستعاب النقل؟
من خلال تحليل المعطيات التارخية و خاصة منذ بداية عصر التدوين و إلى يومنا هذا، نجد أن أغلبية المدارس الدينية لعبت دورا أساسيا في خلق إنفصام بين العقل و الدين، فتارة تبقي على النص جامدا، و تارة تقيده، و تارة تؤوله ثم يصبح التأويل نصا أساسيا، لا يمكن تغييره بتغير الزمان و المكان، و لا يخفى على كل من إهتم بالتراث الفكري الديني للأمة ما حل به من ويلات الدس و التحريف، فصحح ضعيف، و ضعف قوي، و نسب الأمر إلى غير أهله،وصفت كتب بالكمال و التمام بيد أنها عمل بشري خاضع لقوانين البشر(الخطأ و النسيان)، و هذا ما كرس فكرة الخمول الفكري و إبعاد الدين عن أي تدبر و إن صح ذلك كان وفقا لمنهجية في أحسن أحوالها إدعت الوسطية و لم تكن كذلك حسب قول " نصر حامد أبو زيد" و بالتالي سيكون إعمال العقل وفقا لشروط و مناهج و ضعها مفكرون أو علماء حسب رأيهم و إشتهادهم بحكم زمانهم و حالهم.
وهنا أخص بالذكر مسألة النصوص و التعامل معها، و الآليات إلى سبيل إحقاق الغاية من النص، و الإرتقاء بالعقل لنيل دلالة الشرع في المشروع وفقا لما يرضي الشارع.
و لا أعني علم الأصول بحد ذاته و إنما المنهجية المتبعة في إرساء معالم هذا العلم، و هو ما يترتب عليه المحصول المعرفي العام لهذا العلم كشكل الخطاب الديني و تحقيق المناط في أمور الشرع...
و هو ما أدى إلى ظهور كل تلك الفجوات في مقاصد الشرع، فلا يعطل نص سواءً كان قرآن أو سنة صحيحة في سبيل تحقيق مناط إلا و وصف صاحب هذا التعطيل بالكفر و النفاق و الجهل، مع أن بعض الصحاب بل و احد من أعظم صحابة رسول الله صل الله عليه و سلم قد عطل نصا قرآنيا صريحا بينا يترتب عليه حد من حدود الله، و الأدلة تكثر في هذا الموضوع...
و طبعا السنة الشريفة(قولا و فعلا و تقريرا) لم تسلم هي الأخرى فقد تعرضت لأشد أنواع التدليس و التحريف و الكذب و أطفي على بعضها مفهوم القداسة و الصحة بالكامل ككتاب "صحيح البخاري" رحمه الله الذي هو في أكثره صحيح إلا أن بعضا من ما فيه من الأحاديث لا تقبل، على سبيل المثال "الألباني" رحمه الله قد ضعف عشرات الأحاديث من هذا الكتاب و تم تكفيره و وصفه بالجهل لتطاوله على قدسية هذا العمل البشري الخاضع لعوامل التاريخ و نذكر هنا أن الله عز و جل توكف بحفظ القرآن الكريم و ليس صحيح البخاري.
الحديث في هذا الموضوع يطول و له دروب...
ما نريد أن نستخلص هو فشل هذا الخطاب الديني الذي و جد لمسوقات تاريخية في وضع منهجية و سطية تقوم على تقريب العقل و الدين و تحقيق مقاصد الشرع جملة و تفصيلا، فكان من الطبيع ظهور مثل هاذه الأزمات الفكرية و السياسية و الأجتماعية...
قد يبدو للوهلة الأولى أن فكرة الخلود مسألة فلسفية صرفة، أو في الجانب الآخر أي عقائدية بحتة و لكنها في الحقيقة تقف على الأعراف بين طرفي نقيض أريد لهما أن يكونا كذلك، و لكن الفطرة تأبى ، فالله الذي أنزل هذا القرآن و بعث نبيه بالحق هو الذي و هبنا العقل و الأسباب و أمرنا بالتدبر و التفكر فحاشاه أن يأمرنا ثم يمنعنا الأسباب، و أختم قولي بقوله تعالى:
﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الألْبَابِ ﴾ [البقرة: 269].
سيدي محمد عبدو
الفلسفة و الخطاب الديني
أحد, 09/04/2017 - 04:06
.jpeg)


.jpeg)





.gif)