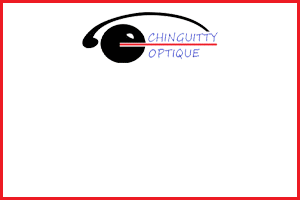تنعقد في هذا الشهر بموريتانيا القمّة العربية التي تأجلت زمنياً وتغيّرت مكانياً بعد أن اعتذرت المملكة المغربية عن استضافتها هذا العام. لكن حتماً مشاكل العرب لم يكن سببها في زمان ومكان انعقاد القمم العربية، فتردّي الأوضاع العربية على المستويين الحكومي والمدني سببه مزيجٌ من العوامل التي تراكمت في الأعوام الماضية فأنتجت ظروفاً لا تُحمَد اليوم عقباها.
إنّ مشكلة تعثّر العمل العربي المشترك تعود أساساً إلى البنية الخاطئة لجامعة الدول العربية، ثمّ إلى غياب المرجعية العربية الفاعلة التي اضطلعت مصر بريادتها، قبل توقيع المعاهدات مع إسرائيل في نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي، ثمّ أيضاً بسبب ما يحدث في البلاد العربية من تدخّل إقليمي ودولي في قضايا عربية داخلية، وبشكلٍ متزامن مع سوء أوضاع عربية في المجالات السياسية والأمنية، وشاملة لمن هم في مواقع الحكم أو المعارضة، وفي ظلّ حالٍ من الجمود الفكري والانشداد إلى غياهب الماضي، وتغييب دور العقل ومرجعيته في الفهم والتفكير والتفسير.
لقد كان من المفترض أن تشكّل صيغة “الجامعة العربية”، عند تأسيسها في مارس/آذار 1945، الحدّ الأدنى لما كانت تطمح إليه شعوب المنطقة من تكامل وتفاعل بين البلدان العربية، لكن العقود الماضية وتطوّراتها الدولية والإقليمية جعلت من صيغة “الجامعة” وكأنّها الحدّ الأقصى الممكن، بل ظهرت طروحات لإلغاء هذه الصيغة المحدودة من التعاون العربي واستبدالها بصيغ “شرق أوسطية” تضمّ إسرائيل ودولاً غير عربية، ممّا يزيل حتّى الهويّة العربية عن أيّ صيغ تعاون إقليمي في المستقبل.
صحيحٌ أنّ “جامعة الدول العربية” هي في الأصل “جامعة حكومات”، وهي محكومة بإرادات متعدّدة لمصالح وأنظمة مختلفة، لكنّ ذلك لم يكن مانعاً في التجربة الأوروبية من أن تتطوّر من صيغة سوق اقتصادية مشتركة إلى اتّحاد أوروبي كامل، بين دول شهدت فيما بينها في قرونٍ مختلفة حروباً دموية طاحنة كان آخرها الحرب العالمية الثانية، بينما التعاون بين الدول العربية أشبه ما يكون بمؤشّرات سوق العملة، يرتفع أحياناً ليصل إلى درجة الوحدة الاندماجية الفورية بين بعض الأقطار، ثمّ يهبط معظم الأحيان ليصل إلى حدّ الانقسام بين الشعوب والصراعات المسلّحة على الحدود، وإلى الطلاق الشامل بين من جمعتهم في مرحلة ماضية صيغ دستورية وحدوية!.
وسيبقى واقع حال الجامعة العربية على وضعه الراهن طالما أنّ الجامعة هي “جامعة حكومات” وليست فعلاً “جامعة دول”، بما هو عليه مفهوم “الدولة” من تكامل بين عناصر (الشعب والأرض والحكم). فالأوضاع الراهنة في البلاد العربية تفتقد عموماً للمشاركة الشعبية السليمة في صناعة القرار الوطني، بينما المجتمعات العربية ما زالت كلّها تعيش الحالة القبلية والطائفية كمحصّلة طبيعية لصيغ الحكم السياسي السائدة فيها منذ قرونٍ عديدة.
إنّ تطوير العلاقات العربية/العربية، باتّجاهٍ أفضل ممّا هي عليه صيغة “الجامعة العربية”، يتطلّب تطويراً لصيغ أنظمة الحكم في الداخل العربي، ولإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل. فالمشكلة الآن ليست في غياب الحياة الديمقراطية السليمة فقط، بل أيضاً في ضعف الهُويّة العربية المشتركة وطغيان التيّارات الطائفية والمذهبية والإثنية في المجتمعات العربية.
أليس محزناً الآن أن تشهد بلادٌ عربية عديدة أزماتٍ أمنية وسياسية ساخنة، بعضها يمكن وصفه بالحروب الأهلية، ولا نجد عملاً عربياً نزيهاً ومشتركاً لوقف هذه الأزمات، بل على العكس نرى تورّطاً لبعض الأطراف العربية في إشعال هذه الأزمات أو عدم تسهيل الحلول المنشودة لها؟!. أليس ذلك أيضاً بدلالةٍ كبرى على مخاطر تهميش دور مصر في أمّتها العربية منذ توقيع المعاهدة مع إسرائيل؟!. وهل يجوز أن يتقرّر الآن مصير أوطانٍ عربية من خلال تفاهماتٍ بين دول إقليمية ودولية كبرى، ولا يكون للعرب دورٌ في تقرير مصير أنفسهم؟!.
ولعلّه من المهمّ جدّاً أن تكون هناك الآن “وقفة عربية مع النفس″ على كلّ المستويات الرسمية والشعبية، وأن تكون هناك مراجعة نقدية للسنوات الخمس الماضية التي شهدت انتفاضاتٍ شعبية ومتغيّراتٍ عديدة، لكن كان في محصّلتها درسٌ صعب للجميع مفاده أنّ مواجهة الاستبداد الداخلي من خلال طلب الاستعانة بالتدخّل الخارجي، أو من خلال العنف المسلح المدعوم معظم الأحيان خارجياً، جلب ويجلب الويلات على البلدان التي حدث ذلك فيها، حيث تغلب حتماً أولويات مصالح القوى الخارجية على المصلحة الوطنية، ويكون هذا التدخّل أو العنف المسلح نذير شرٍّ بصراعاتٍ وحروبٍ أهلية، وبهيمنة أجنبية على القرار الوطني، وبنزعٍ للهويّة الثقافية والحضارية الخاصّة بهذه البلدان. لكن أيضاً فإنّ “التسامح” مع الاستبداد من أجل مواجهة الخطر الخارجي، أو تغليب الحلول الأمنية على الحلول السياسية، دعم كلَّ المبرّرات والحجج التي تسمح بهذا التدخّل الأجنبي المباشر أو غير المباشر. لذلك من المهمّ جداً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى “الحرّية” هو في التلازم المطلوب دائماً بين “حرّية المواطن” و”حرّية الوطن”، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط الآخر حتماً.
لكن هل ما يحدث الآن في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان، ينفصل عمّا حدث قبل ذلك في العراق عام 2003 من احتلالٍ وتفكيك لوحدة الشعب والكيان، وما جرى في السودان أيضاً في العام 2011 من فصلٍ لجنوبه عن شماله؟!
فما تشهده الآن بعض البلدان العربية هو تنفيذ لمشاريع أجنبية تسعى لإعادة تركيب هذه البلدان على أسس دستوريّة جديدة تحمل الشكل “الفيدرالي الديمقراطي”، لكنّ مخاطر هذه المشاريع أنها تتضمّن بذور التفكّك إلى كانتونات متصارعة في ظلّ الانقسامات الداخليّة والدور الإسرائيلي الشغّال، في الجانبين الخارجي الأجنبي والمحلّي العربي، لدفع الواقع العربي إلى خدمة المشاريع الإسرائيلية بإشعال حروبٍ أهليّة عربيّة شاملة تؤدّي إلى ظهور دويلات تحمل أسماءً دينية وإثنية، كإعلان اسم “الدولة الإسلامية” الآن، وهو ما سيبرّر الاعتراف الدولي والعربي بإسرائيل كدولةٍ دينية يهودية.
إنّ كلّ الأطراف الدولية والإقليمية، الخصمة والصديقة لواشنطن، تعتبر الآن “داعش” حالة إرهابية يجب محاربتها. وقد يكون ذلك هو القاسم المشترك الذي تراهن عليه إدارة أوباما من أجل صياغة تسويات سياسية توافق عليها تحديداً روسيا وإيران والسعودية وتركيا ومصر، وتشمل الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولبنان، ممّا يمهّد أيضاً (حسب الأجندة الأوبامية) لتعاملٍ دولي وإقليمي مشترك مع الملف الفلسطيني، قبل مطلع العام 2017، موعد رحيل أوباما عن “البيت الأبيض”.
فربّما تكون أولويّة المواجهة مع “داعش” هي الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً لإدارة أوباما لتحقيق أجندة التسويات السياسية للأزمات المشتعلة في “الشرق الأوسط”، وللحفاظ على المصالح الأميركية بالمنطقة، ولمنع انتشار خطر الإرهاب والتطرّف المسلّح الذي سيسود العالم في حال الفشل بهذه التسويات. فالصراعات الدموية الجارية حالياً لن تقف عند حدود دولة معيّنة بل ستؤدّي تفاعلاتها إلى مزيج من حروبٍ أهلية وإقليمية، وإلى تصاعد حركات الإرهاب في العالم كلّه، وإلى هدم كياناتٍ وأوطان، وليس فقط إلى تغيير حكوماتٍ وأنظمة.
لكنّ الولايات المتحدة هي أيضاً مسؤولةٌ بشكل كبير عمّا حدث ويحدث في العراق وسوريا وليبيا وفي بلدان أخرى بالمنطقة نتيجة السياسات الأميركية التي اتّبِعت منذ مطلع القرن الحالي، والتي استفادت منها إسرائيل فقط، وهي السياسات التي خطّطت لها جماعات أميركية/صهيونية منذ منتصف التسعينات بالتنسيق مع قيادات إسرائيلية، وجرى البدء بتنفيذها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، ثمّ من خلال غزو العراق في العام 2003، ثمّ بدعم الحروب الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، ثمّ بالمراهنة على إسقاط أنظمة عن طريق العنف المسلّح وبدعمٍ لجماعات دينية سياسية، وبالمساعدة على إشعال أزماتٍ داخلية، وبتوظيف المشاعر الطائفية والمذهبية في الصراعات مع الخصوم.
وهاهي واشنطن، ودول أخرى، تحصد نتائج سلبية على مصالحها بعدما ساهمت أيديها بزرع بذور هذه الأزمات المتفجّرة حالياً. لكن الخطر الأعظم هو على شعوب المنطقة وأوطانها، ممّا يتطلّب من الحاكمين والمعارضين العرب وعياً وطنياً وقومياً يتجاوز حدود مصالح الحكومات والطوائف والمذاهب. وهو أمرٌ ما زال غائباً رغم أنّ النيران قد وصلت إلى “منازل وحدائق” أطرافٍ عديدة.
*مدير “مركز الحوار” في واشنطن
مدير “مركز الحوار” في واشنطن يكتب عن قمة نواكشوط (مقال)
اثنين, 18/07/2016 - 12:07
.jpeg)


.jpeg)





.gif)