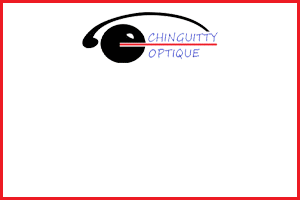وقفت على الربع أستنطقه عن ذكريات المحمديْن الظاعنيْن. أعقاب سيجارة حزينة، صدى ضحكة يزيّنها الأزل، وصور مشتتة من أشياء الحياة. في كل يوم ذكرياته، واليوم لم يسعفني الربع بغير هذه من ذكريات المحمديْن الحبيبيْن (محمد سالم ومحمد شنوف، عليهما من غافر الذنب شآبيب رحمته).
قصائدي في الحبيبين لا حروف لها، والدمع فيهما باق في محاجره، تحتكره الأحزان لنفسها، فهو أعظم من أن يسيل، وأجزل من أن يتدفق. البرق، والحمام، والغزالة الوجناء، وأغصان الطلح، وسويعات الغسق، وشِعر البُداة: تفاصيل كنا نصنع خيوط أخيلتها من أحاديث المساء، حين نحطم حدود العقل، فنتناول المحذور والمحظور، والمقبول والمرفوض، والثابت والمتغير، قبل أن نختم بالهزل، فتأخذ كل دعابة نصيبها من الضحك الوديع. وغدا نلتقي، عند هذا أو ذاك، أو في فيفاء محايدة، مع ثلة من أصدقاء لا شيء يجمعهم غير ذينك الشبليْن، الخلوقيْن، الماجديْن، المفضاليْن، السمحيْن... وكثيرا ما يكونان، في مجالسنا، واسطة السبحة ودرة القلادة. بهما يطيب اللقاء، ومعهما يزدان المحفل، ومنهما تنطلق أولى إشكاليات وشجون الحديث.
كلما فكرت فيهما، انتابني شعور بأن المحمديْن استُخلصا من طيبة النفس وطينة النخوة. كانت الأريحية ديدنهما والسماحة عادتهما والرزانة عنوان حياتهما. كانت حياتهما الخاطفة طاهرة في كنهها، لم تدنّسها أوساخ دهرهما. ظلا نظيفين، نقيّيْن، سالميْ العرض، إلى أن اختارهما الله لجواره، تاركيْن فراغا لم يجد بعدهما من يسده، وهوة استحال ردمها، ورُزْءًا فوق الرثاء لأنه عَصِي على الشكل والفحوى والروي والكلمات. ورغم أن الباكين عليهما كثيرون، والباكيات عليهما كثيرات، إلا أن من تجمدت دموعهم، عاجزين عن التعبير بغير الجحوظ، أكثر بكثير.
واليوم، بعد سنوات من حرقة الفراق ولوعة الوداع الأخير، نرجو من جلسائهما وخلانهما وأصفيائهما، ومن عرفوهما ومن لم يعرفوهما، أن يترحموا عليهما عسى أن يُحشرا مع "الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء".

.jpeg)
.jpeg)






.gif)