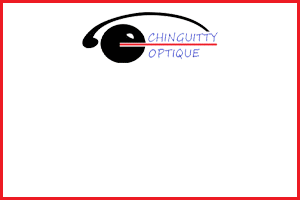يندر أن يكتب الأدب الموريتاني سياقاته التاريخية والثقافية والتحولات الاجتماعية التي مرت بالكاتب أو الشاعر، لأنها في غالب الأحيان غير مرئية بالنسبة له، وربما لا يملك تلك الملكة القادرة على الفرز وغربلة الأحداث في طزاجتها وتجددها اليومي، لأن تدفق هذه الأحداث في نهر الزمن بحاجة إلى حاسة أخرى لالتقاطها وتجميدها في لحظة زمكانية محددة، ليس التجميد هنا من أجل التحنيط بقدرما هو من أجل إعادة النظر وإثراء المشهد، وقراءته بعين المستقبل والتجدد، وهذا ما نجح فيه الشاعر الشاب مولاي علي الحسن، عندما اتخذ من أحد أقدم شوارع نواكشوط وأذيعها صيتا شارع جون كينيدي ثيمة شعرية لنصه. هذا الشارع الذي أصبح في محاولة انقلابية عسكرية (ولطالما اعتدنا الانقلابات العسكرية) على الشاعر يسمى شارع بداه ولد البوصيري، بعد أقل من سنتين من كتابة نصه المعنون ب “نواكشوط.. شارع جون كينيدي ليلا”.
لا يكتفي الشاعر في هذا النص بصورة فوتوغرافية ل”الشارع الكهل”، وإنما يحمله بكل ما فيه من صخب ومن روائح ومن تناقضات تنسحب على مدينة نواكشوط كلها، فمن اللقطة الزمنية الأولى حيث يلف المدينة المتورطة في ليلها الجاثم والمتوشحة شتاء رطيب يخدش أجساد المعوزين، يقدح الشاعر شرارة الزمن الشعري الذي يعترف بالباعة البسطاء وأصدقاء الرصيف:
شتاءٌ رطيبٌ يلُفُّ المدينةَ
واللّيْل يجثُمُ…
لا دِفْءَ، لاَ شمْسَ تحنُو على الباعة البُسطاء
يُقاسُونَ بَرْدَ الرَّصِيفِ وبُؤْسَ الحياة
خُطى العابرينَ تدُقُّ الشّوارعَ….
حلم صغيرٌ
يُضيء ويخفتُ
مِلْءَ الجهاتْ
شتاءٌ بخِيلٌ…
يُوَزِّعُ رائحة الخُبْزِ بينَ الجياع
وينثُرُ رائحةَ العِطْر عطر الرجال على العابرات ضياعَى
إلى ليلهنَّ الخصوصيّْ
شتاءٌ كطعمِ الفراغ….عصِيُّ الصِّفَاتْ
لا يتوانى الشاعر عن كشف خصوصيات المدينة التي تتعرى من حجب المحافظة القشرية، ومن ستر الملائكية المزيفة والمتحايلة على إنسانية متجذرة، تكاد تشف تحت طبقات التكلف التي يضفيها النهار على الأرواح، وكأن المدينة تلعب لعبة الظل والوميض عكس اللحظة الزمنية، فحين تسطع الشمس وتضيء الأشياء في مخابئها تختبئ المدينة تحت رداء المحافظة والتغافل، ولكن ما إن يلقي الليل بستائره السوداء حتى تبدو المدينة عارية الجسد، تبيح تفاصيلها لكل ذي بصيرة وتمنح مفاتنها وتذرو أسرارها في الهواء الطلق.
هنا يختلط الحكّاء بالحكاية، ويتوحد الكاتب بالنص، وتتناغم الكلمات والانزياحات مع جوقة أسرار المدينة وساكنيها الذين يبوحون لهذا الشارع بلواعجهم، ويمارسون على أديمه حريتهم على مرأى صغار يتضورون جوعا، ويتناثرون على جنبات الشارع كما لو كانوا أعمدة صغيرة للنور، حيث في الليل متسع للتشرد، ويحتفظ الشارع كذلك بصورة من التناقض الصارخ بين بنوك تكتظ بالملايين بينما يحرسها رجال جوعى:
ويكتُبُنِي العَابِرُون…
صغارٌ حُفَاةً يلوذوُن باللّيْل..
فِي اللّيْل متّسَعٌ للتشرّد
بين الزوايا
على جنباتِ البقالاتِ
أو في محطّات بيْع الوقودْ…
ويقترِفُ الدّرْبُ ما تشتهيه الطفولةُ فيهم
صغار و”لا يكبرون”
وفي صمتهم لغةٌ غائرَهْ
يضيعُون في زَحْمَةِ العُمْرِ
كاللّحظةِ العَابِرَه
كلنا نرى أولئك الصغار الذين يستجدون المارة على ناصية الشارع منذ عقود وكأنهم لا يكبرون، وإن كانوا بالفعل يكبرون ولكن في كل مرة يأتي جيل جديد يحمل المشعل، ويولد أطفال آخرون يعيشون التجربة نفسها وفي المكان ذاته، ولعل هذا العود الأبدي بتعبير نيتشه هو ما يكشف عن لازمنية الحركة التاريخية للمجتمع، ويعبر عن سلسلة مفرغة يدور فيها الناس والمكان والأحداث، وهي سلسلة صفرية، لدرجة أن “الصغار لا يكبرون”، ففي هذا التعبير أمسك الشاعر بالسر واكتشف خوارزمية الزمن الموريتاني الذي لا يبرح مكانه، وإنما يصدأ فقط كما تصدأ كراسي المقاهي وفناجين القهوة ومواضيع الجدل، وثيمات الحوارات البيزنطية هنا:.
وبيْنَ المقَاهِي على حيْرَةِ يتفرَّقُ وَعْيُ الجُلُوس
جِدَالٌ يطارِدُ صمْتَ المقاعِدِ…يَدْهَمُ صفْوَ البَلاَهَة واللاَّمبالاة
ـ سينتصِرُ العَقْلُ يومًا..على الرَّغْمِ مِن كُلّ هذي الرّمالْ!
ـ نَبِيٌّ جَدِيدٌ سيُبْعَثُ…سوْفَ يَرَى الفُقَهَاء التطوَّر وَجْهًا لَوَجْهٍ….ولَن يرجِعَ المَيّتُونْ!
ـ وما العدْل؟ ماذا تقول القوانين؟ فيمَ التمرّدُ؟ ماذا ستفعلُ لَوْ..؟…كُلُّ هذا هُراءٌ…هُراءٌ…فَلاَ تتْعَبُوا!
ـ والقبيلَة عيْنُ المساواة…لا فرْق بين الشرائح…واحِدَةٌ كلّ هذي البلاد…لماذا اختلاق الصراع؟
ـ ولِي دونكم…هِجْرَةٌ خلْفَ هذا المحيط!
الوعي الشعري والمعرفي المستل من معجم الواقع المعيش، يكشف بصراحة عن تمثل عميق للحظة التي يعيشها الشاعر، ويعبر عن تشبع بمفردات وتفاصيل هذا الواقع برؤية تفكيكية، ونظرة تمتاز بمنسوب كبير من الوعي بالأشياء وبالزمكان في ذاتيهما، وليسا كموجوديْن يكتفي الشاعر بوصفهما من الخارج، فالشاعر هنا يخوض الحياة ولا يكتفي فقط بوصفها.
إنه يحول هذا الركام المحيط به إلى مادة للشعر، حيث ربما يشحذه يقين ما بأن الشعر كامن في كل شيء، وليس كل شيء كامن في الشعر، فجعل من محيطه لغة داخل اللغة:
وينعَسُ فِي شَجَرِ النِّيمِ وَجْهُ الطبيعة….
سيّارةٌ تِلْوَ أُخرى تلطّخُ روحَ المكانْ
سجائرُ تعتنِقُ النَّارَ مَعنَى
فيعرُجُ فوْقَ الجميع…الدُّخانْ
ولا يبْرَأُ الشّارِعُ الكهْلُ من وَجَعِ النَّاس…
دُورٌ تُغَلِّفُ أسرارَهَ
والعمارات ـ أعني قليل العمارات ـ تقضِمُ حصَّتَه
من ترامِي السماء على الأرْض…
الفشل البنيوي للدولة والمجتمع في إنتاج نمط حياتي مديني مستقر، ويملك شرعية ذاتية غير مستمدة من المقولات الماضوية ومن آبار التاريخ القديم، يبدو حاضرا في النص بشكل غير مهادن، وإن ظل يشف ولا يقول، ويلمع ولا يضيء كما هي استراتيجية الشعر في التعبير عن خصوصيته ككلام يوحي ويعتمد على الانزياح، فالمسافة بين الدلالة الحقيقية الاقعية وبين المجاز تعطي فسحة للتأويل، وهنا في هذه الفسحة بالذات التي قد تتسع وقد تنقبض تكمن “لذة النص” بتعبير رولان بارت.
طول هذه المسافة أو قصرها، ومفاجأتها لذهن القارئ بالمزيد من الخدع المنطقية واللامنطقية، هو ما يحدد مستوى اللذة في هذا النص أو ذاك، وعند هذا القارئ أو ذاك؛ خاصة في ظل التباين المعرفي والثقافي بين القراء أنفسهم، ومن هنا أمكننا القول مع بورخيس “إن طعم التفاحة ليس في التفاحة ذاتها، ولا في فم آكلها، ولكنه في التفاعل بين الاثنين”:
حُرَّاسُ لَيْلِ البُنوكِ يجوعُون….
مرْضَى تلبَّسَهُمْ أمَلٌ غامِضٌ
كَيْ يُغافِلَ فِيهم وضوحَ القنوطِ…
نِسْوَةٌ يتسَوّلْنَ…
ينهَشُ صمْتُ الأزقَّةِ أرواحَهُنَّ
بلا رحمةٍ…
إدانة واضحة وصريحة لهذا الفشل البنيوي، والذي حول ناس هذه الأرض إلى معسكرات من المرضى المسكونين بأمل غامض في الشفاء، ولعل “غامض” هنا هي بؤرة التوتر الشعري في هذه الجملة وذروة اللذة الشاعرية، حيث إن الجهل من جهة يجعل هؤلاء المرضى لا يدركون طبيعة مرضهم، وبالتالي سبل العلاج، وقد ينطبق هذا على طبيعة المرض الذي يعاني البلد والسلطة والمجتمع كله منه، ولهذا يظل الأمل “غامضا” بالشفاء ما دام المرض نفسه غامضا.
من جهة أخرى فإن عبارة “غامض” هنا قد تشير إلى فشل المرافق الصحية وندرتها في احتواء المرضى، وهو ما ترك الباب مفتوحا لما يسمى الطب التقليدي والشعوذة وأدى إلى التكاثر الجرثومي لبُرص الريق، والتي يقصدها الناس دون أي يقين مبني على معطى علمي بقدرتها على الشفاء، وإنما يقصدونها لأن هذا “الأمل الغامض” في الشفاء يشحذهم، ويعطيهم راحة نفسية هي الأخرى “غامضة”.
تلتقط عدسة الشاعر هذا المشهد الدراماتيكي والمركز في تناقضه، حيث البنوك، وهي رمز الرأسمالية المتوحشة، وأكبر قطاع نما خلال العشرية الأخيرة من ريع النهب والأموال المشبوهة، بينما من يحرسون هذه الثروة السائلة يتضورون جوعا.
إن هذا المشهد السوريالي الذي يشبه أن يموت المرء عطشا على متن زورق في نهر عذب، تعبر بشعرية عالية وبحس إنساني ملتقط بمهارة عن الوعي الشعري والإنساني المعمق لصاحب النص الذي يلتبس أخيرا، ويترك للعابرين مهمة إكماله، هؤلاء العابرون الذين ليسوا سوى القراء والنقاد، والذين يلمح كل واحد منهم للآخر بإكمال المهمة، سيرا على سنة الشاعر، ليظل النص متجددا ومتدفقا مثل نهر الزمن، خالقا لنفسه مكانة في الشعرية الموريتانية، وحافظا للحظة تاريخية من عمر مدينة نواكشوط، وهذا ما نحتاجه من ضمن حاجات أخرى في الأدب الموريتاني المنبت من سياقه والأصم عن ضجيج المدينة وولولات الجوعى وطقطقات أقدام العابرين والعابرات على الأرصفة المغبرة لشوارع التاريخ:
ثُمَّ….
يلتبِسُ النصُّ!
ماذَا أحَاوِلُ بَعْدُ؟!
سأتركه هكذا.. ناقصَا
والبقيَّةُ…يُكمِلُهَا العابرون!
الشيخ نوح

.jpeg)
.jpeg)